يكذبون ويقولوا ان فى القران تناقضات @@@ (سلسلة)
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع منقول من منتدى آخر وينزل على شكل أجزاء
الاخوة الاحباب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احزننى ما قراته لاحد الاعضاء ان القرآن الكريم يوجد
به تنافضات وسوف اتكلم معكم بحول الله عن
الكلام المتناقض فى القرآن حتى لو وصل الكلام الى اكثر من حلقة
ويا ليت القائمين على هذا الموقع يثبتون هذه الحلقات لاننى ساتكلم بالادلة والبراهين من كتاب الله تعالى وسوف نتوكل على الله ونبدا
الحلقة الاولـــــى
" جاء فى سورة النساء: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)
(1).
ولكننا نجد فيه التناقض الكثير مثل:
كلام الله لا يتبدل: كلام الله يتبدل
(لا تبديل لكلمات الله ) (2): (وإذا بدلنا آية مكان آية..) (3)
(لا مبدل لكلماته ) (4): (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) (5)
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (6): (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (7)
هذه طريقتهم فى عرض هذه الشبهة يقابلون بين بعض الآيات على اعتبار تصورهم ، وهو أن كل آية
تناقض معنى الآية المقابلة لها ، على غرار ما ترى فى هذا الجدول الذى وضعوه لبيان التناقض فى
القرآن حسب زعمهم.
الرد على هذه الشبهة:
الصورة الأولى للتناقض الموهوم بين آية يونس: (لا تبديل لكلمات الله) وآية النحل (وإذا بدلنا آية مكان
آية..) لا وجود لها إلا فى أوهامهم ويبدو أنهم يجهلون معنى التناقض تمامًا. فالتناقض من أحكام
العقل ، ويكون بين أمرين كليين لا يجتمعان أبداً فى الوجود فى محل واحد ، ولا يرتفعان أبداً عن ذلك
المحل ، بل لا بد من وجود أحدهما وانتفاء الآخر ، مثل الموت والحياة. فالإنسان يكون إما حيًّا وإما
ميتا ولا يرتفعان عنه فى وقت واحد ، ومحال أن يكون حيًّا و ميتاً فى آن واحد ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان
فى محل واحد.
ومحال أن يكون إنسان ما لا حى ولا ميت فى آن واحد وليس فى القرآن كله صورة ما من صور التناقض
العقلى إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون. والعثور على التناقض بين الآيتين المشار إليهما محال محال
؛ لأن قوله تعالى فى سورة يونس (لا تبديل لكلمات الله) معناه لا تبديل لقضاء الله الذى يقضيه فى شئون
الكائنات ، ويتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية. ومنها القوانين الكيميائية ، والفيزيائية
وما ينتج عنها من تفاعلات بين عناصرالموجودات ،أو تغييرات تطرأ عليها. كتسخين الحديد أو المعادن
وتمددها بالحرارة ، وتجمدها وانكماشها بالبرودة. هذه هى كلمات الله عزّ وجلّ.
وقد عبر عنها القرآن فى مواضع أخرى ب.. السنن وهى القوانين التى تخضع لها جميع الكائنات ،
الإنسان والحيوان والنبات والجمادات. إن كل شئ فى الوجود ، يجرى ويتفاعل وفق السنن الإلهية أو
كلماته الكلية ، التى ليس فى مقدور قوة فى الوجود أن تغيرها أو تعطل مفعولها فى الكون.
ذلك هو المقصود به ب " كلمات الله " ، التى لا نجد لها تبديلاً ، ولا نجد لها تحويلاً.
ومن هذه الكلمات أو القوانين والسنن الإلهية النافذة طوعاً أو كرهاً قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت)
(8). فهل فى مقدور أحد مهما كان أن يعطل هذه السنة الإلهية فيوقف " سيف المنايا " ويهب كل الأحياء
خلوداً فى هذه الحياة الدنيا ؟
فكلمات الله إذن هى عبارة عن قضائه فى الكائنات وقوانينه المطردة فى الموجودات وسننه النافذة
فى المخلوقات.
ولا تناقض فى العقل ولا فى النقل ولا فى الواقع المحسوس بين مدلول آية: (لا تبديل لكلمات الله) وآية:
(وإذا بدلنا آية مكان آية..).
لأن معنى هذه الآية: إذا رفعنا آية ، أى وقفنا الحكم بها ، ووضعنا آية مكانها ، أى وضعنا الحكم بمضمونها
مكان الحكم بمضون الأولى. قال جهلة المشركين: إنما أنت مفتِرٍ (9).
فلكل من الآيتين معنى فى محل غير معنى ومحل الأخرى.
فالآية فى سورة يونس (لا تبديل لكلمات الله) والآية فى سورة النحل: (وإذا بدلنا آية مكان آية..) لكل
منهما مقام خاص ، ولكن هؤلاء الحقدة جعلوا الكلمات بمعنى الآيات ، أو جعلوا الآيات بمعنى الكلمات
زوراً وبهتاناً ، ليوهموا الناس أن فى القرآن تناقضاً. وهيهات هيهات لما يتوهمون.
أما الآيتان (لا مبدل لكلماته) و(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقد تقدم ذكرهما
فى الجدول السابق.
هاتان الآيتان بريئتان من التناقض براءة قرص الشمس من اللون الأسود:
فآية الكهف (لا مبدل لكلماته) معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات. وهذا هو ما عليه المحققون
من أهل العلم ويؤيده الواقع المحسوس والعلم المدروس.
وحتى لو كان المراد من " كلماتـه " آياته المنـزلة فى الكتاب العـزيز " القرآن " فإنه ـ كذلك ـ لا مبدل
لها من الخلق فهى باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (10).
أما آية البقرة: (ما ننسخ من آية ) فالمراد من الآية فيها المعجزة ، التى يجريها الله على أيدى رسله.
ونسخها رفعها بعد وقوعها. وليس المراد الآية من القرآن ، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل.
بدليل قوله تعالى فى نفس الآية: (ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ).
ويكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأييده رسله بالمعجزات وتتابع تلك المعجزات ؛ لأنها من صنع
الله ، والله على كل شىء قدير.
فالآيتان ـ كما ترى ـ لكل منهما مقام خاص بها ، وليس بينهما أدنى تعارض ، فضلاً عن أن يكون بينهما
تناقض.
أما الآيتان الأخيرتان الواردتان فى الجدول ، وهما آية الحجر: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)
وآية الرعد: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فلا تعارض بينهما كذلك ؛ لأن الآية الأولى إخبار من الله بأنه
حافظ للقرآن من التبديل والتحريف والتغيير ، ومن كل آفات الضياع وقد صدق إخباره تعالى ، فظل
القرآن محفوظاً من كل ما يمسه مما مس كتب الرسل السابقين عليه فى الوجود الزمنى ، ومن أشهرها
التوراة وملحقاتها. والإنجيل الذى أنزله الله على عيسى عليه السلام.
أما الآية الثانية: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فهى إخبار من الله بأنه هو وحده المتصرف فى شئون
العباد دون أن يحد من تصرفه أحد. فإرادته ماضية ، وقضاؤه نافذ ، يحيى ويميت ، يغنى ويفقر ، يُصحُّ
ويُمْرِضُ ، يُسْعِد ويُشْقِى ، يعطى ويمنع ، لا راد لقضائه ، ولا معقب على حكمه (لا يُسأل عما يفعل وهم
يُسـألون ) (11). فأين التناقـض المزعوم بين هاتين الآيتين يا ترى ؟ التناقض كان سيكون لو ألغت
آية معنى الأخرى. أما ومعنى الآيتين كل منهما يسير فى طريقٍ متوازٍ غير طريق الأخرى ، فإن القول
بوجود تناقض بينهما ضرب من الخبل والهذيان المحموم ، ولكن ماذا نقول حينما يتكلم الحقد والحسد
، ويتوارى العقل وراء دياجير الجهالة الحاقدة ؟ نكتفى بهذا الرد الموجز المفحم ، على ما ورد فى الجدول
المتقدم ذكره.
وهناك شبه أخرى يمكن سردها بإيجاز:
1- إنهـم توهـموا تناقضـاً بين قوله تعالى: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم
كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) (12). وبين قوله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة ) (13). وفى عبارة شديدة الإيجاز نرد على هذه الشبهة الفرعية ، التى تصيدوها
من اختلاف زمن العروج إلى السماء ، فهو فى آية السجدة ألف سنة وهو فى آية المعارج خمسون ألف
سنة ، ومع هذا الفـارق العظيم فإن الآيتين خاليتان من التناقض. ولماذا ؟ لأنهما عروجان لا عروج
واحد ، وعارجان لا عارج واحد.
فالعارج فى آية السـجدة الأمر ، والعـروج عروج الأمر ، والعارج فى آية المعارج هم الملائكة والعروج
هو عروج الملائكة.
اختلف العـارج والعـروج فى الآيتين. فاختلف الزمن فيهما قصـراً أو طولاً. وشرط التناقض ـ لو كانوا
يعلمون ـ هو اتحاد المقام.
2- وقالوا أيضًا: إن بين قوله تعالى: (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) (14). وقـوله تعالى: (ثلة
من الأولين وثلة من الآخرين ) (15) تناقضا. وشـاهد التنـاقض عندهم أن الله قال فى الآية (13)(وقليل
من الآخـرين (وقال فى الآية (40) (وثلة من الآخرين) إذ كيف قال أولاً: (ثلة من الأولين * وقـليل من
الآخرين) ثم قال ثانياً (ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين (ولو كان لديهم نية فى الإنصاف ، ومعرفة
الحق ناصعاً ونظروا فى المقامين اللذين ورد فيهما هذا الاختلاف لوصلوا إلى الحق من أقصر طريق.
ولكنهم يبحثون عن العيوب ولو كلفهم ذلك إلغاء عقولهم.
هذا الاختلاف سببه اختلاف مقام الكلام ؛ لأن الله عز وجل قسم الناس فى سـورة الواقعة ، يوم القـيامة
ثلاثة أقسام. فقال: (وكنتم أزواجاً ثلاثة):
*السابقون السابقون. *وأصحاب الميمنـة. * وأصحاب المشئمة.
ثم بين مصير كل قسـم من هـذه الأقسام فالسابقون السابقـون لهم منزلة: " المقربون فى جنات النعيم
"
ثم بيَّن أن الذين يتبوأون هذه المنزلة فريقان:
كـثيرون من السـابقين الأوليـن ، وقلــيلون من الأجيال المتأخـرين
وذلك لأن السابقين الأولين بلغوا درجات عالية من الإيمان وعمل الباقيات الصالحات. ولم يشاركهم من
الأجيال المتأخرة عن زمنهم إلا قليل.
أما أصحاب اليمين أو الميمنة فبلاؤهم فى الإسلام أدنى من بلاء السابقين الأولين. لذلك كانت درجاتهم
فى الجنة أدنى من درجات السابقين الأولين ويشاركهم فى هذه المنزلة كثير من الأجيال اللاحقة بهم
؛ لأن فرصة العمل بما جعلهم أصحاب اليمين ، متاحة فى كل زمان.
ويمكن أن نمثل للسابقين الأولين بأصحاب رسول الله(ولأصحاب اليمين) بالتابعين ، الذين أدركوا الصحابة
ولم يدركوا صاحب الرسالة. واذا صح هذا التمثيل ، ولا أظنه إلا صحيحاً ، صح أن نقول:
إن قليلاً منا ، بل وقليل جداً ، من يسير فى حياته سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن
كثيراً منا من يمكن أن يسير سيرة التابعين رضى الله عنهم.
وعلى هذا فلا تناقض أبداً بين الآيتين:
(ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين).
و(ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين).
3- وقالوا أيضًا: إن فى القرآن آية تنهى عن النفـاق ، وآية أخـرى تُكره الناس على النفاق أما الآية
التى تنهى عن النفاق ـ عندهم ـ فهى قوله تعالى(: وبشر المنافقين بأن لهم عذابًا أليما) (16).
وأما الآية التى تُكره الناس على النفـاق ـ عندهم ـ فهى قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت
النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفـروا من قـبل قاتلهـم الله أَنَّى
يؤفكـون ) (17).
من المحال أن يفهم من له أدنى حظ من عقل أو تمييز أن فى الآية الأولى نهياً ، وأن فى الآية الثانية
إكراهاً ويبدو بكل وضوح أن مثيرى هذه الشبهات فى أشد الحاجة إلى من يعلمهم القراءة والكتابة على
منهج: وزن وخزن وزرع.
ويبدو بكل وضوح أنهم أعجميو اللسان ، لا يجيدون إلا الرطانة والتهتهة ؛ لأنهم جهلة باللغة العربية
، لغة التنزيل المعجز. ومع هذه المخازى يُنَصَّبُون أنفسهم لنقد القرآن ، الذى أعجز الإنس والجن.
لا نهى فى الآية الأولى ، لأن النهى فى لغة التنزيل له أسلوب لغوى معروف ، هو دخول " لا " الناهية
على الفعل المضارع مثل: لا تفعل كذا.
ويقـوم مقامه أسلوب آخر هو: إياك أن تفعل ، جامعًا بين التحذير والنهى ، ولا إكـراه فى الآية الثانيـة.
وقد جهل هؤلاء الحقدة أن الإكراه من صفات الأفعال لا من صفات الأقـوال أما كان الحرى بهم أن يستحيوا
من ارتكاب هذه الحماقات الفاضحة.
إن الآية الأولى: (وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما) تحمل إنذاراً ووعيداً. أما النهـى فلا وجـود له
فـيها والآية الثانية تسـجل عن طريق " الخبر " انحراف اليهود والنصارى فى العقيدة ، وكفرهم بعقيدة
التوحيد ، وهى الأساس الذى قامت عليه رسالات الله عز وجل.
وليس فى هذه الآية نفاق أصلاً ، ولكن فيها رمز إلى أن اليهود والنصارى حين نسبوا " الأبنية " لله
لم يكونوا على ثقة بما يقولون ، ومع هذا فإنهم ظلوا فى خداع أنفسهم.
وكيف يكون الـقرآن قد أكرههـم على هذا النـفاق " المودرن " وهو فى الوقت نفسه يدعو عليهم بالهلاك
بقبح إشراكهم بالله:
(قاتلهم الله).
(1) النساء: 82.
(2) يونس: 64.
(3) النحل: 101.
(4) الكهف: 27.
(5) البقرة: 106.
(6) الحجر: 9.
(7) الرعد: 39.
(8) آل عمران: 185.
(9) انظر تفسير فتح القدير (ج2/232)
(10) تفسير فتح القدير (ج3 ـ ص 333).
(11) الأنبياء: 23.
(12) السجدة: 5.
(13) المعارج: 4.
(14) الواقعة: 13 ـ 14.
(15) الواقعة: 39 ـ 40.
(16) النساء: 138.
(17) التوبة: 30.
ذلك هو موقف إبراهيم الخليل ، عليه السلام ، من الشرك . . لقد عصمه الله منه . . و إنما هي طريقة في الجدال يتدرج بها مع قومه ، منطلقاً من منطلقاتهم ؛ ليصل بهم إلى هدم هذه المنطلقات ، و إلى إقامة الدليل العقلي على عقيدة التوحيد الفطرية المركوزة في القلوب .
(1) (الجامع لأحكام القرآن) ج7 ص25 ، 26 . طبعة دار الكتاب العربي للطباعة و النشر – القاهرة سنة 1387 ه سنة 1967 م .
(2) (الكشاف) ج2 ص30 ، 31 طبعة دار الفكر – بيروت – بدون تاريخ – و هي طبعة مصورة عن طبعة طهران "انتشارات آفتاب – طهران" – و هي الأخرى بدون تاريخ للطبع .
(3) (قصص الأنبياء) ص80 . طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان – بدون تاريخ للطبع .
(3)
يؤكد القرآن أنه لا يمكن للملائكة أن تعصى الله (66 : 6) و مع ذلك فقد عصى إبليس الذي كان من الملائكة ، كما في الآية (2 : 34) فأيهما صحيح؟
الجواب:
الملائكة مخلوقات مجبولة على طاعة الله و عبادته و التسبيح له و به . . فم لا يعصون الله ، سبحانه و تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (التحريم : 6) .
و مع تقرير هذه الآية أن هؤلاء الملائكة القائمين على النار {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} . . يقرر القرآن الكريم أن إبليس - و هو من الملائكة - في قمة العصيان و العصاة : {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} (البقرة : 34) .
و هناك إمكانية للجمع بين معاني الآيتين ، و ذلك بأن نقول : إن عموم الملائكة لا يعصون الله ، سبحانه و تعالى ، فهم مفطورون و مجبولون على الطاعة . . لكن هذا لا ينفي وجود صنف هم الجن - و منهم إبليس ، شملهم القرآن تحت اسم الملائكة - كما وصف الملائكة أيضاً بأنهم جنة - لخفائهم ز استتارهم - . . و هذا الصنف من الجن ، منهم الطائعون ز منهم العصاة . .
و في تفسير الإمام محمد عبده (1265-1323ه/1849-1905م) لآية سورة البقرة : 34 - يقول :
"أي سجدوا إلا إبليس ، و هو فرد من أفراد الملائكة ، كما يفهم من الآية و أمثالها في القصة ، إلا أن آية الكهف فإنها ناطقة بأنه كان من الجن . . و ليس عندنا دليل على أن بين الملائكة و الجن فصلاً جوهرياً يميز أجدهما عن الآخر ، و و إنما هو اختلاف أصناف ، عندما تختلف أوصاف . فالظاهر ان الجن صنف من الملائكة . و قد اطلق القرآن لفظ الجنة على الملائكة ، على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى : {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا} (الصافات : 158) و على الشياطين في آخر سورة الناس"(1) .
و نحن نجد هذا الرأي أيضاً عند القرطبي - في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) - فيقول :
" وقال سعيد بن جبير: إن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم، وخلق سائر الملائكة من نور. . والملائكة قد تسمى جنا لاستتارها، وفي التنزيل: {وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً} (الصافات: 158) ، وقال الشاعر في ذكر سليمان عليه السلام:
وسخر من جن الملائك تسعة :: قياما لديه يعملون بلا أجر "(2)
فلا تناقض إذاً بين كون الملائكة لا يعصون الله . . و بين عصيان إبليس - و هو من الجن ، الذين أطلق عليهم اسم الملائكة - فهو مثله كمثل الجن هؤلاء منهم الطائعون و منهم العصاة .
(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج4 ص133 . دراسة و تحقيق : د. محمد عمارة . طبعة دار الشروق . القاهرة سنة 1414ه سنة 1993م .
(2) (الجامع لأحكام القرآن) ج1 ص294-295 – مصدر سابق - .
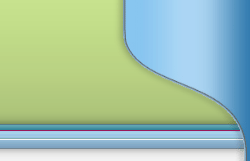

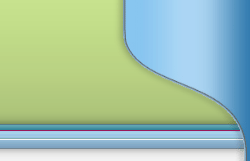


 آخر 10 مشاركات
آخر 10 مشاركات









